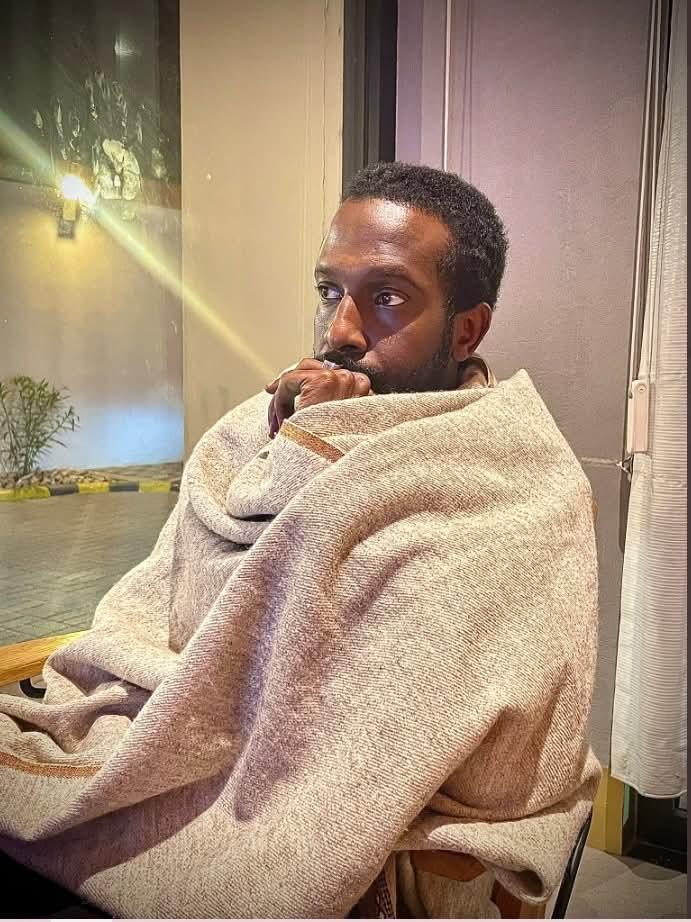استهلال:
أن تحتاج النفس إلى تطبيب أو علاج، فهذا أمر لا يُفارِق وجودها ما دامت النفس معطى يُستكمل نحو نوعٍ من الكمال، وأساليب التطبيب أو العلاج هي في مجملها تعمل عمل المزيل لعوائق عملية استكمالها نحو كمالها المطلوب.
وطب النفس الكلاسيكي يتوجّه قبل أي شيء نحو تمرينٍ لا يقنط للإرادة حتى يحصل للنفس وعيٌ بها، وعند أبو بكر الرازي نجد تصورًا للنفس في علاقتها بعوائق استكمالها على قدر كبير من الاحتراز، إذ أنّ "الضرائب الردية - العوائق - قد تحدث بعد أن لم تكن" وبالإضافة إلى ذلك فإن طبّه النفسي له منطلقات قويمة بجعله—رغم كونه لاهوتيًا—معتبرًا عند القائلين بجوهر واحد وهو المحسوس، وعند الذين يضيفون إليه جوهرًا آخر كنقيض له وهو اللامحسوس أو العقلي.
وما يرومه بحثنا هذا هو العثور على الأسس والمنطلقات الأنطولوجية التي هيأت له هذه الإمكانية ونقصد تصوره عن النفس وطبيعة علاقتها بالعالم في المرض ( الهوى ) والصحة ( تَمَلُّك العقل ) وطبيعة اللذة والألم.
- حول معنى طب النفس/الروح:
قبل أن يعرِض الرازي (أبو بكر) معنى هذا المصطلح والذي هو نفسه عنوان كتابَه قام بتقديم فصلٍ عليه و عنونه ب"في فضل العقل ومدحِه" (1) يستعرِض فيه ما بلغَه الإنسان عبرَ العقل من صنائع واكتشافات علمية، لكنَّ هذا الفصل تختبئ خلفَه تعيينات لعلاقة الإنسان بالعالم من حولِه وما سواه من الأحياء بفضل العقل، فهو ما "به فضلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسَسَّناها وذللناها وصرفناها في الوجوه العائدة منافعها علينا وعليها" (2)؛ إن الفضل الذي اكتسبه الإنسان على غيره من الأحياء يتجلّى في ملكيته لها حتى صار عنده الحق في تقرير ما هو نافعٌ لها، إنّ النفس العاقلة إذا مسؤولة عما في العالم من الأحياء ما دامت عاقليّتها تظهر في تدبيرها نفعَ غيرها نفعَ غيرِها ، وهذا الاستعراض لفضل العقل هو بيان للجلالة التي من شأنه حتى نَرهبَ كلَّ ما قد "يكدّر" صفاءه؛ إنّ الإشارة للعقل بالصفاء ولنقيضه بالكدر هي إشارة دالّة على أنّه ملكة للتدبير واستكمال النفس المُعطاة نحو "وجهةٍ" بعينها، وعليه فإن الكدر و الذي هو ضرائب النفس الردية هي ليست مثار ألمٍ ووَجعٍ فحسب ، وإنما هي تحنِف النفس عن كمالها أيضا .
يعرِّفُ أبو بكر الرازي طبَّ النفس أو الروح عبرَ غايته وهي "إصلاح أخلاق النفس" (4)؛ والأخلاق جمعُ خُلُقٍ وهو الطبع الذي يفيد ويتضمّن معنى الدّمغ وهو رسوخ شيء في شيء حتى صار له طبيعةً، ولبيان المجال الذي يعتمدُ فيه طبُّ النفس عنده فإننا سنعوض كلمة طبيعة بـ"لصيقة" فتكون أخلاق النفس "لصائق النفس"، وهذا التعويض غرضُه أن يظهر الإطار الأنطولوجي لطب الروح من خمسة أبعاد:
1 - أن ما هو لصيق بالنفس قريبٌ منها بحيثية يكون فيها أول ما يتبادر إليها لفعله وإتيانه.
2 - أن اللصيق وإن فقد صفة القرب من النفس فهو يبقى قادرًا على معاودتها.
3- أنّه ما دام اللصيق بالنّفس قادرا على المعاودة فإن العِلاج و إن أُستكمِل فلا بُدَّ مِن أن يتضمّن وقايتها .
4- أن اللصيق بالنفس بما أنه شديد القرب منها فإن علاج النفس وتطبيبها سيكون عبرَ انتزاع ما التصق بها لأنّه سيبدي مقاومةً.
5 - أنّ اللصيق بالنفس هو ذاته طريق لاستكمالها، وإن كان مُمرِضًا؛ لأنها حتى تكون كاملة وكان الكمال شيئًا تنزع نحوه بطبيعتها فإن عوائقه تكون الطريق الوحيد لذلك.
وهكذا يكون تعريف طبِّ النفس عند الرازي هو "انتزاع لصائق النفس". و هذا التأويل ليسَ إضفاءً لمعنى زائد، بل هو استجابة لغايات الرازي النهائية عبرَ فصله في مدح العقل الذي يبتغي منه بناء موقفٍ "احترازي" حتى يكون استكمال النفس نحو كمالها المطلوب ميسَّرًا.
– 1- النفس:
إنّ استشعار جلالة العقل كما يظهره الرازي يجعل علاقة النفس بما قد يهددها علاقة قمعيةً ضرورةً، وهذه الضرورة تتعلق بالجوهر المحسوس (الدنيائيين) كما بغير المحسوس؛ فأن يذكر الرازي أول ما يذكر مصالح الجسد للإشارة لما انتفع به الإنسان بواسطة العقل، فإنّ الأمر يبقى هو ذاته للقائلين بوجود الجوهر اللامحسوس، وهؤلاء بحسب الرازي يذهبون بعيدًا في العلاج لما يترتب على القول بالجوهر اللامحسوس من مسائل كالمعاد والبعث وما ينتج عنهما من ثواب وعقاب (5)، فالسبيل واحدة لاستكمال النفس الناطقة لناطقيتها، والموقف يبقى هو نفسه تجاه ما يهدد العقل و السلوك العملي يبقى هو نفسُه .
ويمكن اشتقاق هذه الضرورة للقمع من طبيعة ما يهدد العقل نفسه، والذي يحدده بالهوى و يعرِّفُه بأنّه " يدعو أبداً إلى اتباع اللذَّات الحاضرة وإيثارها من غير فكر ولا روِّيّة في عاقبة، ويحُث عليها ويُعجِّلُ إليها (6)، فبما أن الهوى يحمل النفس على أن تُبادِرَ فهذا يعني أنّه "مُريدٌ" بالطبع، ويغدو قمع النفس له ضرورة، لأن القمع حين يتعلّق بالكائن الحي فهو يفترضه كائنًا مريداً، ومن ثم فهو يتوجه بالتحديد إلى صرف المريد عن ما يُريدُه.
بناءً على ذلك فإنّ النفس مجالٌ للصراع بين إرادتين، وحتى عقلها المبجّل لا ينبثقُ دون إرادتها لقمع هواها، وهاتان الإرادتان تمثل كلٌّ منهما تقويمين قيميين ( أكسيولوجيا ) للوجود؛ لأنّه إذا كان الهوى "يؤثِر" فهذا يعني أنّه يقوم بعملية تفضيل لشيء بالنظر لشيء لآخر، إلا أنّ هذا التفضيل الذي يُسقط العاقبة في حالة الهوى في الالتذاذ بالمُتاح الحاضر فإنّه لا يستطيع القيام بذلك إلا باختزال علاقة النفس بالعالم إلى علاقة لها بموجود حاضِر مُتعَيّنٍ جزئي.
1.1 - النفس الهوائمية والعالم:
نعني بالنفس الهوائمية النفس التي تتبع الهوى، وإسقاط العاقبة من قبل هذه النفس حين تُباشرُ فعلاً بعينه تجاه موجود جزئي ومتعيّن، يعني أنّ النفس يسقط عنها البعد العلائقي للعالم أو الوجود، بمعنى أن الموجود الجزئي ينقسم وينفصل عن الكل ليصبح هو الكل عينه، وبصورة محددة يمكن أن نقول أن الموجود الجزئي الذي تباشره النفس الهوائمية يصيبه طغيان يُحجب عبرَه غيره وعلاقاته معه.
إنّ طابع الهوى في علاقته بالعالم هي العلاقة التي للفهم/verstand عند فردريش هيغل به، فالفهم يعتبر جزئياته ساكنة ثابتة منعزلة، لكنَّ الأبين لهذا التطابق بين الطريقة التي ينكشف فيها العالم عبر الهوى عند الرازي وهيغل تظهر عبر الطبيعة الإدمانية للنفس على هذا الموجود الجزئي/المنقسم الذي طغى على كلّ غير له أو انفصل عنه واختزل الكلية في نفسه، يتحدث الرازي عن أنّ الهوى يقلب ما قد يكون ترفًا بالنسبة للنفس إلى جعله ضرورةً للعيش (7) وباعتبار ذلك تظهر علاقة إدمانية أو يكون العالم بالنسبة للنفس الهوائمية موضوعا للإدمان ، لكنّ هذا الإدمان يجد أساسه في طريقة التقويم الخاصة بالهوى؛ فحين يقوم الهوى باختزال كلية الموجود إلى موجود جزئي معيّن فإن النفس إذ تريد، فلن تريد إلا هو، لأنّه في الهوى و بالنسبة إليه لا يوجد إلا هو و بذلك فإنّ العلاقة بين إرادة الهوى و المُراد أو الرغبة و المرغوب ليست علاقةً بين شيئين مختلفين ، و إنّما يمثِّلان وِحدةً ، وعليه فهو حين يصف هذا الوقوع غير الواعي في هذا الانقلاب لما يعدّ ترفًا إلى ضرورة، ويشبهه بالقول أن صاحبه يكون "كالحيوان المخدوعة بما ينصب لها في مصايدها حتى إذا حصلت في المصيدة لم تنل ما خدعت به ولا أطاقت التخلّص مما وقعت فيه" (8)؛ فإنه يشير إلى إعادة إنتاج الهوى لذات نفسه واللصيق المؤسس لكل لصيق يعيق النفس عن استكمالها لنفسها، ولا يؤكد الهوى نفسه إلا حين ينكشف العالم إثر اختزاله في موجود جزئي معين كموضوع مدمن عليه، والهوى إذ يريد إذا فهو يريد انطلاقًا من الوهم.
والمقابل الهيجلي لطبيعة الهوى هذه عند الرازي تحت اسم الفهم تظهر في إعادة الإنتاج لذات البعد الضمني المؤسس لفعل النفس إذا تهوى مريدةً، فهو حينما يبذل قصارى جهده لكي يمدَّ نطاقَه بلوغًا إلى المطلق، لا يسعه مع ذلك إلا أن يعيد إنتاج نفسه دون نهايةٍ منهمكًا بها(9).
بيد أن السؤال الذي يكون من الأهمية بمكان هو: إن كان قمع الهوى يغدو ضروريًا بقدر ما نعرِف جلالة العقل وبقدر ما نعرِف الذي يُسقطه الهوى أي العاقبة وهو يباشر ويملي على النفس فعلاً تجاه موجود بعينه مختزلا كلية الموجود فيه و مفتتا كل علائقية له بغيره مِن موجودات العالم ، بحيثيّة قد تفضي إلى اكتساب الألم من حيث قدّرت النفس الالتذاذ (10)؛ أفلا يكون ذلك غير كافٍ لأن الألم سيُحصّل كذلك عبر القمع وتبقى احتمالية النجاة من العاقبة قائمة؟ لنجيب على هذا الأمر سنقصِد إلى سطرٍ هو آخر سطرٍ يقع في الفصل الثاني من الكتاب والذي يتحدث عن زمِّ الهوى وقمعِه.
يقول الرازي في سياق يتحدث فيه عن معالم تؤكد نجاح الإنسان في زمِّ هواه بأن السرور بهذا الفعل والذي له طابع المرارة، كما يصف في موضع لا يتأكد بمعنى لا يخلص من هذه المرارة، إلا حين يمتدح الناس المضطِّلع بهذا الأمر ويشتاقون إلى مثل حاله (11)، إن هذا الامتداح والإطراء الذي ينتهي بأن يشبه فردٌ فردًا و يطمئن بأنَّ فعلاً مزموعًا هو ذو قيمة ، له حضور في غير محل في تفسير منسوب إلى الشيخ محي الدين ابن عربي في سورة يوسف حين ثبت النبي يوسف عليه السلام أمام امرأة العزيز حتى أرادت بلوغ ما هو عليه من الأمر والوجهة في حين أرادت في البدء أن يشاركها ما تزمع، وفي سورة النصر حيث تعني الآية "ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً" إشارة من الله إلى النبي محمد عليه السلام أنه إذا رأيت الناس "مجتمعين كأنهم نفس واحدة تستفيض من فيض ذاتك قائمة مقام نفسك وهم المستعدون الذين كانت بين نفسه عليه السلام وأنفسهم علاقة مناسبة ورابطة جنسية توجب اتصالهم به بقبول فيضه"، إنّ ما يمكن قوله عن هذه النصوص للرازي وابن عربي -رحمهما الله- هو أنّ اعتزام الآخر على أن يرغب في عين ما رغبناه ويشتاق له هو الاعتراف بحسب النظر الهيجلي والذي يجعل من رغبة الإنسان رغبة تستحق نسبتها إلى الإنسانية، ما نستفيدُه في هذه النقطة هو أنّ علاج النفس بانتزاع لصائقها يحدث ويعرِفُ الفرد أنّه قد أنجزه وبلغه فقط حين يعترف الآخر به بأن يرغب في عين ما قد رغبه هذا الفرد مرة وأدام رغبتَه فيه.
1.2 - النفس العاقلة والعالم:
إنّ مجرد قدرة النفس بدرجة من الدرجات على قمع هواها يدل عند الرازي على عاقليتها وعلى إتاحتها لذاتها إمكانية عيش معقول، فقمع الهوى يقول به ويوجِبُه كل عاقل دنيائيا كان أو غير ذلك، والاختلاف يكون في درجة القمع (12)، وبتحليل إيتمولوجي لكلمة عقل في المعاجم العربية نجد معنى ذو بُعد وظيفي لها، فالعقل يأتي بمعنى الملجأ والحِصن من عاقبة، وعليه فهو كملكة لها وظيفة إبيستمولوجية تقوم على تمييز الحق عن الباطل أو الحسن عن القبيح، يكون غرُضها الأساس أن تُميز لأجل أن تُحصّن نفسها، وإن ما به الإنسجام مع هذه المعاني المعجمية عند الرازي وطبِّه النفسي هو وضعه الواضح للعاقبة/الألم كشيء إذا تم تجنّبه، كان قمينا بأن يشير إلى عاقلية الإنسان؛ فما دام الهوى يريد انطلاقًا من وهمٍ فإن العاقبة قد توجَد في الذي بدا لذيذا، وما دام العقل ينطلق من الحقيقة فإن إرادته للذة ستتحقّق، والسبب الرئيس لكون العاقل يُصيب ما أراد هو أنّ فعل القمع للهوى يؤجِّل الإرادة حتى يستبين المُراد، ويكون الحصول عليه قابلاً للتقدير بحسب الحاجة؛ وهذا الفعل تتبيّن أهميته في أنّه يذود عن النفس الوقوع في إنقلاب المُراد من كونه ترفًا إلى ضرورة.
يقوم العقل بدور المُخلِّص من أوضاع مُشفقة وبائسة؛ إذ لولاه "لكان حالنا حال البهائم والأطفال والمجانين" (13)، وبما أنّه الشيء الذي بفضله ملكنا غير العاقل/الناطق وسسناه حتى قررنا ما فيه نفعه له ولنا، فإن العقل الذي ينتج بقدر ما يتم التغلّب على الهوى يعني إمكانية الإضطلاع بالمسؤوليّة، وهي تنبع قبل كل شيء من قدرته على التقدير بحسب الحاجة؛ لأن فعل التقدير يكون قصداً واعياً بنفسه ومُتثبّتاً، فالعاقل لا يُطلِق الشهوة التي يدعوه الهوى لتلبيتها إلا بعد "التثبّت" والذي يتحدّد بحصول اليقين أنّ المُراد الذي يدعو إليه الهوى خالٍ من كل شبهة بالعاقبة (14) ، و هذا التثبّت هو ما يقوم بالدور الوقائي من لصائق النّفس في حالِ إنتزاعِها ؛ لأنّه الواجِب القيام به في كل حين تباغتنا لذّة حاضِرة و يميل بنا نحوها هوانا .
فما العالم الذي ينفتح حين تكون النفس عاقلة؟ لا إجابة مباشرة عند الرازي عن ذلك، لكن بما أنّ حضور النظر البراغماتي بينٌ عنده في تعيين قمع الهوى بالإسطقس والمبدأ (15) لكل أمراض النفس باختلاف المذاهب والمواقف الأنطولوجية، فهذا يعني أنّ علاجَه المقترح له موقف أنطولوجي سابق لهذه الأضداد، يتعلّق هذا الموقف بمفهومه للطبيعة باعتبارها حالة تُعبّر عن الإكتفاء، والذي يُشير إلى إمكانية خلو النفس من الألم الذي تُولِّدُه الحاجة، العيش المعقول إذا أو الإمكانية التي يفتحها التعقّل للإنسان في العالم هي الإكتفاء به؛ إن هذه النظرة هي ما تحمل الرازي على إطراح كثيرٍ من المساعي الإنساني من مثل المجد والمراتب والمناصب وحب الظهور الذي قد يسبب التحدث بالكذب والوله والعشق وكرز الأموال والبخل والإسراف التي تُشعر الإنسان بالامتلاء الذي قد يكفيه، لكنّ الاكفتاء بالعالم عنده يكون عبر التنازل عن هذه فيصبح الإنسجام مع الطبيعة إمكانية تظهر بقدر ما يطرح الإنسان المساعي التي يندفع إليها عبر الألم، إنّ العقل إذا هو منظور تقويمي/أكسيولوجي تستبعِد طبيعتُه تراتبيّة القيَم التي يضعها الهوى.
1.3 - الطبيعة التقوية للعقل:
في اللغة يشير فعل الأمر "اتّقي" إلى التجنُّب، وبما أنّ العقل كمنظور تقويمي يعتبر أولاً ما يُسقطه الهوى، ونقصد اعتبار العاقبة، والتي بحسب الرازي يكفي النفس أن يظهر لها شُبهة منه لتُمسك عمّا تُريد، فنستطيع أن نقول إن أول ما يتبدى من خلال فعل العقل هي التقوى، وفي المقام الأول هي إمكانية تحكم النفس في المصير؛ لأن التثبّت الذي هو شرط لا بد للعاقل أن يستوفيه حتى يطلق الشهوة التي يهوى ليضمن تحقيق لذته، يقتضي تكوين الرأي الذي هو من جملة ما يعترف به الآخر عند من قمَع هواه.
إنّ هذا الرأي ليس النظر الفلسفي ولا الفكري، وإنما هو الموازنة والتقدير اللذان يفترضهما تقويم شيء من الأشياء بالنظر للطبيعة وحالة الاكتفاء الذاتي التي تخلقه للنفس.
2- اللذة والألم:
اللذة والألم عند الرازي وثيقتان الصلة بالطبيعة، ولا توجد لذة إلّا إذا خرجنا عن الطبيعة عبر الألم وعدنا لها؛ وشدتها تكون بقدر شدّة الخروج منها (16)، إن الألم يسبق بالضرورة اللذة؛ بيد أنّ النفس قد يعرِض لها وهمٌ أنّها قد تلتذُّ دون أن يسبق ذلك تألّمها، يرجع الرازي هذا التوهّم إلى أنّ عملية الإدراك التي للنفس لا تكون قادرة على إدراك الفروق الصغيرة أو أنّ النفس قد مكثت في حالة خارجة عن الطبيعة لزمن حتى اعتادته (17)، وهذا الوهم بأنّ اللذة لا تربطها أي علاقة بالألم لا يُمكن أن يجد له مصدرًا إلا في حالة عددنا إدراك النفس لمنطقة تتلقى الانطباعات أو الإحساسات وتتأثر بها تحت شرط واحد، وهو أن يكون الانطباع الذي تتلقاه مختلفًا عن الحالة التي هي عليها بفرقٍ يحدِث في حالتها نقلةً، وإدراك له هذه الطبيعة يمكن عده إدراكًا بـ"تصيِّرِ" النفس، فاللذة بهذا الاعتبار تفترض ضمناً أسبقية زمنية لنقيضها عليها وهي تدرك باختلافها عن حالة الخروج من الطبيعة.
كان للطبيعة معنى لدى أفلاطون في محاورة قراطيلوس حيث تعني ما يصمد تجاه ما يتجاذبه في كل الاتجاهات (18)، وبما أن الهوى شغله الشاغل هو إغتنام اللذة من موجود حاضر مُغفلا كل علائقية، فإنه بهذا المعنى لا تملك النفس الهوائمية أي طبيعة، وتكون مختلفة وممزقة بقدر الحاضر عندها ويدعوها إليها هواها، وهذا القول يبقى صحيحًا بالنظر لقول الرازي في فصل معنون ب"في تعرِّفِ الرجل عيوبَ نفسه" (19)، فالنفس بفضل هواها هي أبداً تستحسن نفسها وأفعالها وتستصيبها، وهذه الخاصة للهوى في علاقة النفس بذاتها تحمل النفس على الجهل بنفسها وعلى الأخَص عيوبها؛ وهذا العماء عن نفسها هو عمى عن طبيعتها، لكن لا يعني عمى النفس عن طبيعتها أنها غير موجودة، وحتى نقرر ذلك يجِب أن ننظر لنتيجة مهمة في حال قامت النفس هواها، وهي أن قمع الهوى بما أنه يعصم النفس من مباشرة الموجود الجزئي الحاضر، فهو بالنظر للذة والألم "يُصَمِّدُ" النفس أمام ما يتنازعها ويتجاذبها، وبذلك فهو يُملِّكُها "طبيعةً" ، ويذكر الرازي ثلاث حالات يجب عندها قمع النفس وهي: إذا دخلت شبهة عاقبة، وإذا كانت اللذة والألم إن أطلقت النفس هواها راجحتان بالتكافؤ، وأخيراً حتى إن لم يكن هناك عاقبة ويضع لهذه الحالة مبرراً وهو أن تُمرَّن النفس ذاتها حتى إذا واجهتها عواقب رديّة، كان قمع النفس عليها يسيراً سهلاً (20)، فإذا كانت اللذة يسبقها الألم زمناً أو الخروج عن الطبيعة وتتحقّق بالعودة إليها، وكان قمع النفس لهواها إمساكاً عن اللذة، فإن قمع الهوى مكوثٌ في الطبيعة وصمود أمام ما يتنازعها، والطبيعة عند الرازي هي ما كان يعنيه أفلاطون، وقمع الهوى هو إمكانية تملّك النفس لطبيعة أو حقيقة، سيّما أننا قد حددنا كيفيّة علاج النفس بانتزاع اللصيق بها والذي يعيق استكمالها لنفسها، فإن مما يجعل الهوى أمرًا غير طبيعي هو قابليّته لأن يُنتزع ويبعَد عن النفس.
3- خاتمة حول دلالة طبِّ النفس عند الرازي والدين:
ما يجب وضعه أخيراً بالاعتبار هو أنّ كتاب الرازي أمر الأمير بإعادة كتابته، وبما أنّ الشأن السياسي متعلّقٌ بالمصلحة العامة التي يجد فيها كلُّ الأفراد أنفسهم معنيين بها، فهذا يعني أنّه طبُّ نفسٍ كوسموبولوتي-كوني، يرى إمكانية "وحدة" سلوكية عمليّة، لأن الكيفيّة المحددة للإنسان عبر العقل لا تكون إلّا بغلبة اللاعقل أي الهوى، وهذا لا يتحقق إلّا حين يعترف بنا الآخر بنزوعه ورغبتِه فيما نحن عليه.
ومن ناحية ثيولوجية-دينية فإن النصوص الإبراهيميّة وغيرها الكثير التي تقوم بإدانة الهوى أو الأهواء يجد الرازي عبرها إمكانية طبِّ نفسي واضِحة؛ فالهوى ضد السؤال عن الوجود أو الحقيقة لأنّه يختزله/ا في جزء هو الكل، وهكذا يكون الهوى ذو ارتباطٍ وثيق بالتناهي والمؤقت، والذي يأفل والمشروط وكل ما رادف ذلك وشاكله من مفاهيم.
الهوامش:
1. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 17.
2. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 18.
3. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 19.
4. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 20.
5. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 24.
6. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 21.
7. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 23.
8. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 23.
9. ماركوزه، ه. (1984). نظرية الوجود عند هيجل (إبراهيم فتحي، مترجم). بيروت: دار التنوير. ص. 51.
10. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 23.
11. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 32.
12. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 31.
13. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 18.
14. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 22.
15. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 23.
16. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 36.
17. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 37.
18. ديكسو، م. (2010). أفلاطون: الرغبة في الفهم. تونس: منشورات دار سيناترا - المركز الوطني للترجمة. ص. 67.
19. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 33.
20. الرازي، أ. ب. (1982). رسائل فلسفية مضاف إليها قطع من كتبه المفقودة. بيروت: منشورات دار آفاق الجديدة. ص. 22.
 (1).png)